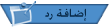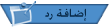مصطلحات الدراســة :
أ- أساليب المعاملة الوالدية( Parental Treatment Styles ) :
يعرف محمد عماد الدين إسماعيل أساليب المعاملة الوالدية في التنشئة الاجتماعية بأنها كل ما يراه الآباء ويتمسكون به من أساليب في معاملة الأطفال في مواقف حياتهم المختلفة (محمد عماد الدين إسماعيل،24:1989)
أبعاد أساليب المعاملة الوالدية وهي كالتالي :
1.أسلوب التشجيع : ويقصد به ميل الوالدين لمساعدة الطفل وتشجيعه والوقوف بجانبه في المواقف الصعبة بطريقة تدفعه قدماً إلى الأمام .
2.أسلوب التوجيه للأفضل: ويقصد به توجيه الطفل نحو النجاح في الدراسة و العلاقات حتى يكون عضواً نافعاً في المجتمع وله قيمته وكيان . (محمد السيد عبدالرحمن ، 1989 : 229 )
3. أسلوب القبول الوالدي: ويقصد به الدفء والمحبة الذي يمكن للآباء أن يمنحوه لأبنائهم وقد يعبر عنه إما بالقول أو بالفعل في أشكال السلوك . (ممدوحة سلامة ،1986 : 14 )
4.أسلوب الحماية الزائدة : ويقصد به اتباع الوالدين الحماية و الخوف على الطفل بصورة كبيرة أكثر مما يرى زملاءه وأصدقاءه يجدون عند آبائهم ، وأن والديه يعملان على حمايته من كل مكروه ولايريدان أن يتعرض لأي موقف يؤذيه جسمياً أو نفسياً ، ويلبيان له كل رغباته ولا يرفضان له طلباً (علاء الدين كفافي ، 1989 :222).
5.أسلوب بث القلق والشعور بالذنب: ويقصد به اتباع الوالدين في تربية الطفل إنهما يتبعان في تربيته مختلف الأساليب التي تثير ضيقه وألمه غير العقاب البدني وتثير لديه هذه الأساليب مشاعر النقص والدونية ، وتحط من هذه الأساليب مثل :التأنيب والتوبيخ واللوم والتقريع والسخرية وإجراء المقارنات في غير صالح الطفل ، كما يشمل هذا الأسلوب تذكير الوالدين للطفل بالعناء الذي تحملاه في سبيله ، كما يشمل مطالبته بمستوى أعلى من السلوك والتحصيل ويتضمن هذا الأسلوب أيضا الابتزاز العاطفي من جانب الوالدين باسغلالهما عاطفة الطفل نحوهما لإجباره على طاعتهما ، كما يشمل هذا الأسلوب التخويف والتحذير الذي يأخذ شكل النصيحة وليس شكل التهديد.
6.أسلوب الإهمال : ويقصد به ان الوالدين لايهتمان به ، بحيث إنه لا يعرف مشاعرهما نحوه بالضبط .
7.أسلوب الرفض : ويقصد به أنهما لايتقبلانه وأنهما كثيرا الانتقاد له ، ولايبديان مشاعر الود والحب نحوه ، ولا يحرصان على مشاعره ولا يقيمان وزناً لرغباته ، بل العكس ما يحدث حيث يشعر الطفل بالتباعد بينة وبين والديه .
8.أسلوب القسوة : أنهما عقابيان ، يلجآن دائماً إلى عقابه بدنياً ( الضرب )أو يهددانه به إذا اخطأ ، أو إذا لم يطع أوامرهما .
9.أسلوب التحكم :أنهما يقيدان حركته ولا يعطيانه الحريه الكافية للحركة والنشاط كما يريد ، ويدرك الطفل أن والديه يعمدان إلى رسم خطوط محددة له ليس له أن يتخطاها وعليه أن يتصرف ويسلك كما يريد الوالدان .
10. أسلوب التذبذب: ويقصد به أنهما لا يعاملانه معامله واحدة في الموقف الواحد ، بل إن هناك تذبذباً قد يصل إلى درجة التناقض في مواقف الوالدين . وهذا الأسلوب يجعل الطفل لا يستطيع أن يتوقع رد فعل والديه إزاء سلوكه كذلك يشمل هذا الأسلوب إدراك الطفل أن معاملة والديه تعتمد على المزاج الشخصي والوقتي وليس هناك أساس ثابت لسلوك والديه نحوه .
11.أسلوب التفرقة : ويقصد به أنهما لا يساويان بين الإخوة في المعاملة ، وأنهما قد يتحيزان لأحد الإخوة على حساب الآخرين ، فقد يتحيزان للأكبر أو للأصغر أو للمتفوق دراسياً أو لأي عامل آخر (علاء الدين كفافي ، 1989 : 228 ).
ب- تقدير الشخصية AssessmentPersonality :
يقصد به التقدير الكمي لكيف يري ويدرك الفرد نفسه فيما يتعلق بسبع نزعات شخصيه وهى:
1-العدوانية / العداء :Hostility / Aggression بما في ذلك العدوان الجسمي واللفظي والسلبي وعدم القدرة على التغلب على مشاعر العداء والكراهية تجاه الآخرين.
2-الإعتمادية Dependency : ويقصد بها الاعتماد النفسي لشخص على شخص أو أشخاص آخرين ليجد التشجيع أو الطمأنينة أو العطف أو السلوك أو الإرشاد واتخاذ القرار
3-تقدير الذات Self-Esteem: ويقصد به تقويم الفرد العام لذاته فيما يتعلق بأهميتها وقيمتها ، ويشير التقدير الإيجابي للذات إلى مدى قبول الفرد لذاته وإعجابه بها وإدراكه لنفسه على أنه شخص ذو قيمة جدير باحترام وتقدير الآخرين ، أما التقدير السلبي للذات فيشير إلى عدم قبول المرء لنفسه وخيبة أمله فيها وتقليله من شأنها وشعوره بالنقص عند مقارنته بالآخرين .
4-الكفاية الشخصية Self- Adequacy : ويقصد بها مدى تقويم الفرد لذاته فيما يتعلق بمدى كفاءته للقيام بالمهام العادية وبشكل مناسب ، ويشير الشعور بالكفاية إلى إدراك الفرد لذاته على أنه كفء وقادر على معالجة الأمور ، وأنه ناجح أو قادر على النجاح فيما يعرض له من أمور أو ما يضطلع به من مهام . أما عدم الكفاية والنقص فيشير إلى شعور الفرد بعدم كفايته لعدم قدرته على النجاح في مواجهة المطالب اليومية للحياة العادية .
5-التجاوب الانفعالي Emotional Responsiveness : ويشير إلى قدرة الفرد على التعبير بصراحة وتلقائية وحرية عن انفعالاته تجاه الآخرين وبصفة خاصة مشاعر الدفء والمحبة تجاههم ، أما عدم التجاوب الانفعالي فيشير إلى العلاقات التي تتسم بالاضطراب والتصنع وتلك التي تتخذ كدفاع.
6-الثبات الانفعالي Emotional Stability : ويقصد به مدى استقرار الحالة المزاجية للشخص ومدى قدرته على مواجهة الفشل والنكسات والمشكلات ومصادر التوتر الأخرى بأقل قدر من الانزعاج والإحباط
7-النظرة للحياة World view : ويقصد بها تقويم الفرد العام للحياة والكون إما على إنه مكان آمن طيب غير مهدد أو كمكان ملئ بالخطر والشك والتهديد وعدم اليقين( ممدوحه سلامه ، 1991: 4-7) .
جـ ـ توكيد الذات (( Self-assertion :
يعرف ولبي ( Wolpe ) توكيد الذات على أنه " التعبير المناسب عن أي انفعال – عدا القلق – نحو شخص آخر ، وتشمل هذه الانفعالات التعبير عن مشاعر الصداقة والوجدان و المشاعر التي لا تؤذي الآخرين( في: طريف فرج , 1988 : 52 ) .
أما عبد الظاهر الطيب ( 2001 : 9) فيعرف التوكيدية على أنها " مفهوم يشير إلى حرية التعبير الانفعالي وحرية الفعل سواء أكان ذلك في الاتجاه الايجابي أي في اتجاه التعبير عن الأفعال والتعبيرات الانفعالية الايجابية الدالة عن الاستحسان والتقبل وحب الاستطلاع والاهتمام والحب والود والمشاركة والصدق والإعجاب أم في الاتجاه السلبي أي في اتجاه التعبير عن الأفعال والتعبيرات الدالة على الرفض وعدم التقبل والغضب والألم والحزن والشك والأسى ولذلك فهو مصطلح قريب من مصطلح الحرية الانفعالية " .
التعريف الإجرائي لتوكيد الذات :
يُعرف الباحث توكيد الذات إجرائياً بأنه " سلوك يغطى كل التعبيرات المقبولة اجتماعياً عن الحقوق والمشاعر الشخصية، وبأنه السلوك الذي يمكن الشخص من التصرف بحسب أفضل مصلحة له، دون الشعور بقلق لا داعي له، والتعبير عن حقوقه دون التعرض لحقوق الآخرين وتقاس عن طريق إيجاد متوسط مجموع الدرجات التي يحصل عليها مفردات العينة على مقياس توكيد الذات المعد لذلك " .
د- الاضطراب القرائي ( ( Dyslexyia :
وعرفت لجنة أعضاء الجمعية الأمريكية للدسلكسيا (1994) اضطرابات القراءة بأنها " خلل عصبي ، دائماً ما يتوارث في العائلة ، يعرقل اكتساب ومعالجة اللغة ، وهذا الخلل يختلف في درجات شدته ويظهر على شكل اضطرابات في اللغة الاستقبالية والتعبيرية بما فيها المعالجة الفونولوجية في القراءة والكتابة والتهجئة وبعض الأحيان في الرياضيات ( جاد البحيري ، 2005).
 « آخــر المشـاركــات »
« آخــر المشـاركــات »